عنوان الموضوع : ديناميكية البناء اللغوي -تعليم سعودي
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
ديناميكية البناء اللغوي
البناء اللغوي للقرآن هو قاعدة الإعجاز الأساسية فيه، فلقد كانت اللغة بين يدي القرآن الكريم مطواعة لأغراضه ومقاصده، يشكلها كما يريد، ويوظفها كما يشاء، يختار من مفرداتها أخفها وأيسرها وأعذبها، ويصنع منها نظما غريب المنوال، ليس له في اللغة سابق مثال، وهذا النظم البديع قادر على أن يزلزل الجبال، وأن يهز الكون كله، والأهم من هذا كله أنه يهز الإنسان من داخله، ويخلقه خلقا جديدا، وذلك لما فيه من الديناميكية والطاقة.
ولقد تكلم أهل العلم عن أساليب القرآن وبديعه ونظمه، وسوف نستعرض بعض ما قيل في هذا الصدد، ولكن ما يعنينا هنا في هذه الأساليب: الديناميكية، ونقصد بها استخدامه لأساليب تثير الحركة والانتباه في ذهن الإنسان، مثل: الاستفهام والاستثناء والنداء، وكذلك استخدامه لتعابير مختلفة وتكراره لبعض التعابير في الموضوع الواحد بصيغ مختلفة، وموضوع المشترك والمترادف والمبهم ونحو ذلك، وذلك كله مما ذكره العلماء في بحوثهم عن القرآن، ولكنهم لم يلتفتوا إلى موضوع الديناميكية في هذه الأساليب، وأثرها في وعي الإنسان. ونبدأ بأول هذه الأساليب وهو التشبيه.
يتبــــــــــــــع
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
أولا: التشبيه، وهو:
(الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى)، وهو كثير في القرآن كما هو الحال في اللغة أيضا، وتشبيهات القرآن جميعها سواء كانت مفردة أو مركبة، تمثيلية أو غير تمثيلية تدفع بالفكر في آفاق عليا، وتحرك الخيال في اتجاهات متعددة وعوالم مختلفة، خذ مثلا قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ (القارعة: 4) وتأمل كيف ربط في هذا التشبيه بين حركة الناس وما يصحبها من تدافع وتصادم وهول واقتحام بحركة الفراش المتطاير المتدافع المقتحم، فقد تحدث عن المستقبل كما لو كان حاضرا، وربط بين الدنيا والآخرة في آية واحدة، ثم أعقبها بقوله: ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (القارعة: 5)، والعهن هو الصوف والمنفوش: الذي شرع في الذهاب والتمزق، فانظر إلى ثبات الجبال وقوتها كيف صار هباء، ففي آيتين اثنتين تبين ما تؤول إليه صورة العالم من التبدل والمغايرة يوم القيامة، وذلك من خلال التشبيه الذي يثري الخيال تدفقا وحيوية وإثارة. ولنتأمل من التشبيه المركب قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: 261) فانظر إلى صورة الإنفاق ﴿ يُنْفِقُونَ ﴾ استحضارا للحالة الراهنة وتحريضا على البذل، ومقارنته مع صورة متأنقة بديعة من متحف الطبيعة، تبدأ بحبة أنبتت وصيغة الماضي مقصودة هنا، وكأن الثواب أسبق من العمل، وذلك دفعا لما يتوهمه الكافرون من أن الإنفاق هدر للمال، فما هو في الحقيقة إلا نماء وزيادة، هذه الحبة نمت وأعطت سبعة سنابل، في كل سنبلة مئة حبة!! ويأتي بعد ذلك الكرم الإلهي الممدود: ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾، هكذا ينقلك القرآن في رحلة عجيبة بين الإنفاق الذي هو في حقيقته زرع للحياة بالمحبة والتواصل والتكافل، وزرع للآخرة أيضا، يحصده المرء هناك، وبين نتيجة هذا الزرع وما يعقبه من نماء دنيوي وأخروي متمثلة بصورة هذه الحبة النموذجية المعطاءة، وبين الصورتين يتحرك فكر المؤمن بحركة ديناميكية تجمع بين الدنيا والآخرة والزرع والحصاد. ومن التشبيه المركب أيضا قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الجمعة: 5)، وهي صورة دقيقة مفعمة بالحركة لأولئك الذين حملوا وهنا استخدم صورة الماضي ثم أعقبها بصورة المضارع ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ ﴾ استحضارا للذهن وتشخيصا للصورة أمام الناظرين، وماذا حمل هؤلاء؟ لقد حملوا التوراة التي هي نور الله، بيد أنهم رفضوا الحمل، وناءوا به، فتلاعبوا كي يتخلصوا منه، فمثل هؤلاء كالحمار الذي يحمل أسفار لا ينتفع بها، ولا ينال منها إلا مؤونة الثقل، ووجه الشبه عقلي، وهو: (حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه)، فانظر كيف نقلك التشبيه بين أمور متعددة أعطت الفكر صورة حية نابضة لحقيقة بني إسرائيل الذين لم يستفيدوا من مصاحبة كتاب ربهم شيئا سوى العناء والمقت الإلهي. لنتأمل أيضا قوله تعالى في صفة شجرة الزقوم: ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ (الصافات: 65)، وهو من التشبيه الوهمي عند البلاغيين، كيف ربط القرآن من خلال التشبيه بين الطلع وبين رؤوس الشياطين وبين الزقوم في ديناميكية عجيبة جمعت بين الدنيا والآخرة والغواية وسببها ونتيجتها، فرؤوس الشياطين هي التي ضللت الكافرين وساقتهم إلى هذا الغذاء الذميم، في عملية مدارها كله على القبح، فرأس الشيطان قبيح، والضلال قبيح، وعقابه قبيح، وشجرة الزقوم قبيحة، والأكل من هذه الشجرة قبيح.. وهكذا نجد أن التشبيه أداة من أدوات الديناميكية التي استفاد القرآن من طاقتها التعبيرية في بيان أغراضه.
ثانيا: الاستعارة:
وهي إحدى وسائل التعبير الديناميكية، وهي عند البلاغيين: (اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، لعلاقة المشابهة)، وقد وردت في آيات كثيرة، منها: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: 6) أي: (الدين الحق)، فانظر إلى حيوية الأسلوب القرآني كيف جعل الدين الحق الموصل إلى الله صراطا مستقيما، والمستقيم كما هو معلوم في الهندسة أقرب مسافة بين نقطتين، فأقرب الطرق إلى الله هو هذا الدين القويم. ووردت الاستعارة في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة: 257). فانظر كيف جعل الكفر على تعدد مناهجه وصوره ظلمات، وكيف جعل الهدى نورا، وكيف جعل النقلة من الكفر إلى الإيمان نقلة من الظلمات إلى النور، والنقلة من الإيمان إلى الكفر نقلة من النور إلى الظلمات، وتأمل البون الشاسع بين النقلتين من خلال استعارة موحية فعالة مؤثرة وهي استعارة النور للتوحيد والظلمات للشرك. ومن ألوان الاستعارة قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل: 112). تأمل في تعبير (أذاقها) وما فيه من الاتحاد والاندماج، فالإنسان عندما يذوق شيئا ويبتلعه، يصبح جزءا لا يتجزأ منه، فالعذاب متغلغل في كيان القرية كله تغلغل الغذاء في جسم الإنسان، فلا يمكن أن ينفصم عنه. ثم تأمل الاستعارة الموحية الموحية: ﴿ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ وما في اللباس من الستر والغطاء للجسم، وكأن الجوع والخوف فصل لباسا لتلك القرية، فلا تستطيع أن تنفك عنه، إنه تعبير موحي للمصاحبة والملازمة الدائمة التي تعبر عن انهماك تلك القرية في ألوان من العذاب الحسي الغليظ. كما عبر القرآن عن حياة الشرك بالموت، وعن الإيمان بالحياة، قال تعالى: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام: 122)، فالنقلة إلى الدين الحق هي نقلة من الموت إلى الحياة. وفي صورة أخرى يعبر القرآن عن عملية تمكن الضلال في نفوس المنافقين وتمسكهم به ونبذهم للهدى بعملية الشراء، قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (البقرة: 16) وتصوير أخذ الضلالة ونبذ الهدى بالبيع والشراء دليل على صفقة خاسرة في عملية تجارية فاسدة ولذلك قال: ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾، ومقابل هذه التجارة هنالك تجارة أخرى رابحة وهي تجارة المؤمنين، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (الصف: 10) وهنا يتجلى جمال التعبير القرآني الذي جعل عملية الإيمان والكفر كعملية البيع والشراء، تشبيها للمعقول بالمحسوس، وتقريبا للمجرد إلى الأذهان بع/بارات موحية فعالة من خلال الاستعارة.
__________________________________________________ __________
ثالثا: المجاز المرسل:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، يعرفه البلاغيون بأنه: (ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه)، ومنه إطلاق المسبب وإيراد السبب كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ (غافر: 13)، فالرزق هنا المراد به الغيث الذي يكون به الرزق، وعبر بالرزق عن الغيث لأمه مسبب عنه، وهكذا يربط بين الغيث والرزق في مخيلة الإنسان، ومن المجاز المرسل تسمية الشيء باعتبار ما سيؤول إليه، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ (النساء: 10)، فالمراد بقوله ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ﴾. مالا سيكون نارا يوم القيامة، وقد سماه نارا حتى يجعل النفس تنفر منه وتبتعد عن أكله وكأنه نار حقيقية يلتهمها عبيد المال سفها وطغيانا. ومن المجاز المرسل تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ﴾ (النساء: 2)، فاليتيم عندما يعطى المال وقد بلغ سنة التكليف لم يعد يتيما، وإنما سماه يتيما باعتبار ما كان عليه ليحافظ على نزعة الرحمة عناية به. ومن علاقات المجاز المرسل: إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ (العلق: 17)، فالمراد دعوة أهل النادي، ولكنه طلب منه دعوة النادي بما فيه زيادة في التحدي والمبالغة. ومن علاقات المجاز المرسل: تسمية الشيء باسم آلته، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (إبراهيم: 4). فاللسان هنا المراد به اللغة، وأطلق لفظ اللسان دون اللغة لأنه أداتها وآلتها. وهكذا نجد أن المجاز المرسل يولد طاقة فكرية هائلة في الكلام مستندا إلى ما بين المعاني من علاقات لا شتى لا تقوم على المشابهة كما هو الحال في الاستعارة.
رابعا: المجاز العقلي:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، يعرفه البلاغيون بأنه: (إسناد الفعل، أو معناه، إلى ملابس له، غير ما هو له، بتأول)[6]، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (القصص: 4)، فإسناد الذبح والاستحياء إلى فرعون لأنه السبب الآمر بهذه الأفعال الشنيعة التي يقوم بها جنوده، وقد يكون الإسناد إلى الزمان، كما في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ﴾ (المزمل: 17)، والأحداث التي في ذلك اليوم هي التي تجعل الولدان شيبا وليس اليوم في حد ذاته، كما يكون الإسناد إلى المكان، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ (الزلزلة: 2)، والأرض لا تفعل ذلك من تلقاء نفسها وإنما يأمرها الله بذلك، وقيمة هذا المجاز أنه يلفت الإنسان إلى العوامل المؤثرة في الأفعال من أسباب وزمان ومكان وغير ذلك إلى جانب الفاعل الحقيقي للحدث.
خامسا: الكناية:
وهي إحدى أدوات التعبير الديناميكية، يعرفها البلاغيون بأنها (لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادته)، وقد وردت الكناية في مواضع من القرآن، قال تعالى: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (المائدة: 75) فقوله كانا يأكلان الطعام كناية على أنهما من البشر، وأنهما (كسائر أفراد البشر في الاحتياج إلى ما يحتاج إليه كل فرد من أفراده بل من أفراد الحيوان) [8]، وقوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: 223) هو (من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة، على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم) [9]، وعليه فالكناية أسلوب غير مباشر لأداء المعنى مع قرينة ودليل ملموس، وقد وظفها القرآن لتفعيل التعبير اللغوي، والرقي بأدائه إلى رتبة الإعجاز.
سادسا: الأمر:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، وأكثر ما يكون جماله لما يخرج عن مقتضى الظاهر، كالتهديد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (فصلت: 40)، أو التعجيز كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: 23)، أو الإهانة كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ﴾ (الإسراء: 50)، أو التسوية كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ (التوبة: 53)، أو الاحتقار كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ (الشعراء: 43).. فصيغ الأمر كلها في هذه الآيات ونحوها ذات معان دالة، تتجاوز المعنى المباشر للأمر وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام إلى معان أخرى بلاغية تستشف من إيحاءات الكلام وسياقاته المختلفة.
سابعا: النهي:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، وهو في الأصل: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، ولكنه قد يخرج إلى معان أخرى بلاغية تستشف من إيحاءات الكلام وسياقاته المختلفة، وذلك كالدعاء كما في قوله تعالى: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: 286)، فقد حملت دلالات النهي في الآية السابقة معاني الدعاء للعلي الكبير أن يتولى المؤمن برعايته وحفظه ونصره، فخرجت بذلك عن مطلق النهي وأعطت الكلام دفئا وحيوية في محراب التبتل إلى الله العلي الكبير.
__________________________________________________ __________
ثامنا: الاستفهام:
وهو في الأصل طلب المتكلم العلم بشيء لم يكن معلوما له من قبل، ولكن القرآن قد يتجاوز هذا الغرض إلى أغراض بلاغية أخرى، كالتشويق كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (الصف: 10)، أو التسوية كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (البقرة: 6)، أو التعجب كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ (هود: 72) أو التقرير، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إبراهيم ﴾ (الأنبياء: 62)، أو الإنكار، كما في قوله تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأعراف: من الآية80) فالاستفهام في هذه الآيات خرج عن غرضه الأصلي إلى معان أخرى ذات إيحاءات بلاغية جديدة، تشحذ الفكر وتوقظ الخيال للبحث وراء المعاني الجديدة.
تاسعا: التمني:
وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو بعيد الحصول، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنعام: 27)، فالعودة إلى الدنيا مستحيلة، وهنا يتحرك خيال الإنسان بين الآخرة والدنيا، ويقف متحسرا إذا كان مقصرا، ويدرك أن ثمة فرصة ما زالت أمام عينيه، فيسرع ويبادر إذا كان من أهل السعادة، وأما بعيدالحصول فكما في قوله تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ (القصص: 79)، فها هنا يرسم أسلوب التمني صورة لأولئك السذج من العوام الذين يخدعهم بريق الذهب، فيمنونه ولو كان على حساب كل شيء! وأسلوب التمني هو من الأساليب الحيوية التي تثير الانتباه، وتحرك العقل، وقد وظفه القرآن لغرض بث الطاقة التعبيرية الخلاقة في بيانه العظيم
عاشرا: النداء:
وهو طلب إقبال المخاطب على المتكلم، وهو كثير في القرآن الكريم، فمنه ما هو موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا بوصف النبوة، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: 64)، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (لأنفال: 65)، وقد يخاطب بوصف الرسالة، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ (المائدة: من الآية41)، ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك ﴾ (المائدة: من الآية67)، ومنه ما هو خطاب للثقلين، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ (الرحمن: 33)، ومنه ما هو خاص بالمؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ (التحريم: من الآية8)، ومنه ما هو خاص بالكافرين كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (التحريم: 7)، ومنه ما هو خاص بالمنافقين كما في قوله تعالى: ﴿ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (التوبة: 66)، وقد يخرج النداء عن غرضه الأصلي لأغراض أخرى كالتحسر في قوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (يّـس: 30)، وبالجملة فإن أساليب النداء من الأساليب الحيوية التي تبث النشاط في نفس المخاطب، وتجعله يلقي السمع وهو شهيد.
أحد عشر: الأسلوب الحكيم:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، يعرفه البلاغيون بأنه: (وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيها على أنه الأولى بحاله، أو المهم له)، كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ﴾ (البقرة: من الآية189)، سألوا عن تكوين الأهلة فوجههم إلى السؤال على ما هو أولى بهم أن يسألوه وهو فائدة تلك الأهلة، ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: 215)، فقد سألوا عن مادة الإنفاق فأجابهم عن مواضع الإنفاق، متضمنا الإشارة إلى مادته وهو ان يكون من خير، والأسلوب الحكيم أسلوب تربوي فعال، يوجه السائل إلى ما هو أولى بحاله أن يسأله، ويرتفع به عن سذاجة ما طرحه من سؤال إلى أفق أعلى حين يجيبه على ما هو أولى له بالسؤال عنه.
اثنا عشر: الالتفات:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، يعرفه البلاغيون بأنه: (التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة - التكلم والخطاب والغيبة - بعد التعبير عنه بطريق آخر منها)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء: 1)، فالانتقال من الغائب إلى المتكلم فالغائب فيه طاقة تعبيرية معجزة، لأن هذا الأسلوب يدفع الرتابة عن الكلام ويجعل المتلقي يتأمل في الخطاب الرباني بكل حواسه، ويتابعه كلمة كلمة وحرفا حرفا.
يتبــــــــــــــــــــــــــــع
.
__________________________________________________ __________
ثلاثة عشر: الإيجاز:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، يعرفه البلاغيون بأنه: (اختصار بعض ألفاظ المعاني ليأتي الكلام وجيزا من غير حذف لبعض الاسم، ولا عدول عن لفظ المعنى الذي وضع له) ، والعرب مولعون بالإيجاز حتى قالوا: البلاغة هي الإيجاز، وكتاب الله عز وجل في ما عرضه من موضوعات وقصص وتشريع وعقيدة، لهو في غاية الإيجاز، متضمن سعادة الدارين، ودستور للفرد والجماعة على حد سواء، ومن أساليب الإيجاز قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ (البقرة: من الآية179)، وهذه الآية تشتمل على إيجاز القصر، وقد قال عنه السيوطي: (معناه كثير، ولفظه يسير، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قَتل قُتل به كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم، وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ماكان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم: القتل أنفى للقتل - بعشرين وجها أو أكثر) ، وصور الإيجاز كثيرة، وهو ضربان: إيجاز بالحذف وإيجاز قصر، وقد احتوى القرآن على النوعين، وليس بخاف ما يثيره الإيجاز من كوامن البحث والتنقيب على المعنى الذي يحتويه، فهو يبعث الطاقة في نفس القارئ أو المتلقي من أجل الإحاطة بالمعنى الذي قد يكون دقيقا أو غامضا مما يحتاج معه إلى مزيد من البحث والتأمل.
أربعة عشر: التكرار:
وهو إحدى أدوات التعبير الديناميكية، لأنه يدفع إلى التأمل في ما كرر، وسببه، وفائدته، ويعرفه البلاغيون بأنه: (أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد)، ومثاله في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ (القمر: 17)، وحول حكمة تكرار هذه الآية يقول السيوطي: (قال الزمخشري: كرر ليجددوا عند سماع كل نبأ منها اتعاظا وتنبيها، وأن كلا من تلك الأنباء مستحق لاعتبار يختص به، وأن يتنبهوا كي لا يغلبهم السرور والغفلة)، وصور التكرار كثيرة في الذكر الحكيم، (ومن ذلك تكرير القصص، كقصة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء، قال بعضهم: ذكر الله موسى في كتابه في مئة وعشرين موضعا. وقال ابن العربي في القواصم: ذكر الله قصة نوح في خمسة وعشرين موضعا، وقصة موسى في تسعين آية. وقد ألف البدر بن جماعة كتابا سماه المقتنص في فوائد تكرير القصص، وذكر في فوائده: أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله، أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة، وهذه عادة البلغاء)
خمسة عشر: ذكر الخاص بعد العام:
وذلك (للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه، تنزيلا للتغاير في الوصف نزلة التغاير في الذات)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: 98)، فقد دخل جبريل وميكال ضمن الملائكة دخولا أوليا ثم ذكرا على التفصيل بعد ذلك للعناية بشأنهما، وهذا يدفع العقل لمزيد من التأمل في شأن هذين الملكين الكريمين.
ستة عشر: الإيغال:
وهو (ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى دونها)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (يّس: 21)، فتأمل كيف ختمت الآية بوصف الرسل بالهدى، مما يجعل السامع يغرى باتباعهم، فهو اتباع مجاني لا يكلف شيئا من جهة، ثم هو اتباع على طريق الهداية من جهة أخرى.
سبعة عشر: التذييل:
وهو: (تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد) ، ومثاله قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (سـبأ: 17)، فانظر كيف جعل إنزال العقاب بسبب الكفر، ثم جعله خاصا بالكفرة، وهذا التذييل له أهميته، لئلا يتوهم غير الكافر إذا عصى ربه أنه سيعاقب عقاب الكافر، فالعقاب الماحق لا يكون إلا للكافرين.
ثمانية عشر: الاحتراس:
وهو: (أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (المائدة: 54)، قال الخطيب القزويني مبينا سرا قوله تعالى: ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾: (فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين، لتوهم أن ذلتهم لضعفهم، فلما قيل: أعزة على الكافرين، علم أنها منهم تواضع لهم، ولذا عدي الذل بعلى لتضمينه معنى العطف، كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع، ويجوز أن تكون التعدية بعلى لأن المعنى: أنهم مع شرفهم، وعلو طبقتهم، وفضلهم على المؤمنين، خافضون لهم أجنحتهم)
تسعة عشر: التتميم:
وهو (أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ (البقرة: من الآية177)، فقوله على حبه فيه تتميم في غاية الحسن، فهو ينفق المال مع حبه له، أو هو ينفقه حبا لله، ومنه أيضا قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ (الإنسان: 8) أي مع اشتهائه والحاجة إليه، وهنا يكون الإنفاق أعظم أجرا عند الله تعالى.
يتبـــــــــــــــــــــــــع
__________________________________________________ __________
عشرون: الاعتراض:
وهو (أن يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين معنى، بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة) ، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (النحل: 57)، فكلمة سبحانه تنزيه في غاية الحسن وقع بين كلامين متصلين، فأفاد معنى جديدا، ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ (لقمان: 14). فقوله عز وجل: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ اعتراض في غاية الحسن للتنبيه على فضل الأم خاصة التي تعبت بالحمل والولادة والتربية، والتي تكون أكثر عرضة للعقوق من جهة الأبناء إذا كبروا.
واحد وعشرون: وضع المضمر موضع المظهر:
وذلك (ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه، فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لعقبى الكلام كيف تكون، فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فضل تمكن، وهو السر في تقديم ضمير الشأن أو القصة)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (الإخلاص: 1)، فضمير هو جعل الذهن يتنبه لما يأتي بعده، فجاء لفظ الجلالة فأنست النفس بذكره وعلمت أنه المراد بعد الضمير، فتمكن في النفس غاية التمكن.
اثنتان وعشرون: المطابقة:
وهي: (الجمع بين متضادين، أي معنيين متقابلين في الجملة)، ومثالها قوله تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ﴾ (الكهف: من الآية18)، فقد طابق بين الأيقاظ والرقود، ومنها قوله أيضا: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ (الأنعام: من الآية122)، فقد طابق بين الميت وهو اسم والإحياء له وهو فعل، كما طابق بين النور والظلمات، والمطابقة كثيرة في كتاب الله وبخاصة بين السماء والأرض والجنة والنار والحق والباطل والهدى والضلال.. وهي بالإضافة إلى جمالها الأسلوبي ذات قيمة معنوية، لأنها تجعل الفكر يتأمل بين الأشياء وما يضادها سواء على صعيد المحسوسات أو المجردات، مما يتيح للعقل البشري أن يلم بالمعرفة من جميع أطرها وأشكالها في ما يتعلق بالأمر ونقيضه.
ثلاث وعشرون: المقابلة:
وهي: (أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو اكثر، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب)، ومثالها قوله تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (التوبة: 82)، فقد قابل بين الضحك القليل والبكاء الكثير، وهي مقابلة اثنين باثنين، ومثالها أيضا قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ (الليل: 5-10) وهي من مقابلة أربعة بأربعة، والمقابلة ذات حسن أسلوبي وأداء حيوي يجعل الذهن متابعا للمتكلم عند استخدامها، منتبها إلى الكلمات والجمل وما بينها من اتفاق وتباين، مما يدفع عنه السآمة والملل، ويغريه بالمتابعة والتأمل.
أربعة وعشرون: تشابه الأطراف، وهو:
(أن يختم الكلام بما يناسب ابتداؤه بالمعنى) ، ومثاله قوله تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الأنعام: 103)، فاللطيف يتناسب مع قوله (لا تدركه الأبصار)، والخبير يتناسب مع قوله ﴿ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾، فصار الكلام وحدة متوائمة وسبيكة واحدة، وهذا من خصائص أسلوب القرآن التي يكاد ينفرد بها عن ما سواه.
خمسة وعشرون: الإرصاد، وهو:
(أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (التوبة: من الآية70) فقوله تعالى: (فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ) يجعل الذهن يتساءل: ما الذي أودى بهم إذا؟ فيأتي الجواب: ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، وهذا أسلوب فعال لتنبيه العقل وإثارة الفكر.
ست وعشرون: المشاكلة، وهي:
(وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا) [29]، ومثالها قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (الشورى: من الآية40)، فقد سمى العقاب العادل سيئا؟ لأنه جاء بسبب السيئة نفسها، ووقع في الكلام مجاورا لها، والجزاء من جنس العمل؟ وهو وإن كان عادلا، ولكنه جاء نتيجة عمل سيئ، فالنتيجة مترتبة على السبب، وهذا معنى إضافي يمكن إضافته لتأثير المشاكلة في هذا السياق.
سبعة وعشرون: العكس والتبديل، وهو
(أن يقدم جزء من الكلام ثم يؤخر)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (الروم: 19). وهنا يتداخل الموت والحياة، فكل منهما يخرج الآخر، وكل منهما يصنع صاحبه، ومن ثم لا غرابة أن يكون عقب الموت حياة جديدة للإنسان، ومن ثم عقب بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾، فسبحان من يخلق الشيء وضده، وينتج الأشياء من أضدادها وهو على كل شيء قدير.
ثمانية وعشرون: اللف والنشر، وهو:
(ذكر متعدد على التفصيل، أو الإجمال، ثم ما لكل واحد، من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (القصص: 73)، فالسكن يكون في الليل وابتغاء الفضل يكون في النهار، والمعول في اللف والنشر على حكم العقل ليرد كل جملة في السياق إلى صاحبها، وهذا أولى من سياق كل متعدد مع ماله على حدة، وهو أسلوب فعال من أساليب اللغة التي اعتمد عليها القرآن الكريم في طاقته التعبيرية.
تسعة وعشرون: الجمع، وهو:
(أن يجمع متعدد في حكم)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (الكهف: من الآية46). فقد جعل الزينة للاثنين معا: المال والبنون، ومن ثم فلا تكون الزينة كاملة إذا نقص أحدهما من حياة الإنسان.
يتبـــــــــــــــــــــع
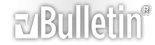



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس